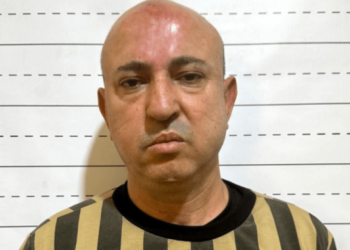شكّل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 نقطة تحوّل في أزمة اللجوء السورية الممتدة، إذ أزال العائق السياسي الرئيسي الذي أبقى ملايين السوريين في المنفى لأكثر من عقد.
وقد أثار هذا التحول السياسي استجابة فورية؛ ففي غضون ستة أشهر، عاد نحو 450 ألف لاجئ عبر الحدود الدولية إلى ديارهم، وبدأ 1.2 مليون نازح داخلي رحلة العودة إلى مناطقهم الأصلية. ومع ذلك، فإن هذه الحركات، رغم أهميتها الظاهرة، لا تمثّل سوى نسبة ضئيلة من مجموع 6.8 ملايين لاجئ و6.9 ملايين نازح داخلي، والذين يشكّلون معاً واحدة من أكبر أزمات التشريد القسري في التاريخ المعاصر.
تتطلب هذه الظاهرة الناشئة للعودة تحليلاً نقدياً ضمن إطار متعدد الأبعاد، وتقدّم الحالة السورية نموذجاً على أن الانتقال السياسي، رغم ضرورته، لا يُعد كافياً لتمكين العودة المستدامة في سياقات التشريد القسري المطوّل.
يُواجه مفهوم “العودة الطوعية والآمنة والكريمة” – كما هو مُكرّس في القانون الدولي للاجئين والممارسات الإنسانية – تحديات كبيرة عند تطبيقه في سياقات فُكّكت فيها أجهزة الدولة بشكل منهجي، وقُطعت فيها العقود الاجتماعية بعنف، ودُمّرت فيها البُنى الاقتصادية. تجسّد سوريا ما يمكن تسميته “بنية النزوح التحتية”: حالة يتشكل فيها الدمار المادي، والانهيار المؤسسي، والتفكك الاجتماعي، كعوائق ذاتية التكريس تُعيق العودة، وتستمر حتى بعد تغيير النظام.
تجادل هذه المقالة بأن عملية عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط الأسد تُبرز ثغرات بنيوية في الأطر الدولية التي تتعامل مع التشريد القسري المطوّل. ففي حين أزال التحوّل السياسي أبرز عقبة أمام العودة، كشف في الوقت ذاته شبكة معقدة من التحديات المادية والقانونية والاجتماعية والنفسية التي تُقوّض فاعلية الاستجابات الإنسانية التقليدية. هذه التحديات – والتي تتراوح من قضايا بسيطة كتوثيق الملكية، إلى أخرى أكثر عمقًا كتحقيق العدالة الانتقالية – تكشف أن العودة ليست حدثاً منفرداً، بل عملية متعددة الأوجه تتطلب تزامنًا بين إعادة الإعمار المادي، وبناء المؤسسات، والتعافي الاقتصادي، والإصلاح الاجتماعي. ومن هنا، تدفع التجربة السورية نحو إعادة صياغة لمفهوم “عودة اللاجئين”، يتجاوز المعايير السياسية الأولية ليشمل مجمل الشروط اللازمة لإعادة الإدماج الحقيقي.
الاقتصاد السياسي للعودة
تُبرز الظروف المادية التي يواجهها العائدون السوريون أزمةً عميقة في قدرة الدولة، تتجاوز بكثير تحديات إعادة الإعمار التقليدية في مرحلة ما بعد الصراع. وينتج عن التقاء البنية التحتية المدمرة، والأنظمة الاقتصادية المنهارة، والأطر القانونية المجزّأة ما يمكن وصفه بـ “مأزق ثلاثي” يواجه العائدين: فهم لا يستطيعون استعادة ممتلكاتهم من دون وثائق، ولا يمكنهم الحصول على هذه الوثائق من دون مؤسسات فاعلة، ولا يمكن إعادة بناء هذه المؤسسات من دون تسوية جوهرية تتعلق بتوزيع السلطة والموارد.
أزمة حقوق الملكية والتوثيق: التعدّدية القانونية في الممارسة
تُظهر بيانات المسح أن 20% فقط من اللاجئين السوريين يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للسكن أو الأراضي أو الممتلكات، ما يعكس عمق أزمة حقوق الملكية التي تواجه العائدين. تتقاطع هذه الأزمة التوثيقية مع الأطر القانونية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والتي تزيد من هشاشة العائدات من النساء. فالطبيعة الأبوية لقانون الملكية السوري – حيث تبقى الهوية القانونية للمرأة مرتبطة بأقاربها الذكور – تضع عوائق إضافية أمام الأسر المعيلة من النساء في سعيها لاستعادة ممتلكاتها. ويؤدي التفاعل بين الأعراف الاجتماعية وبين تلف السجلات الرسمية إلى شكل من أشكال الإقصاء القانوني، لا يقتصر على نزع الملكية، بل يُشكك في إمكانية حصول المرأة على “جنسية اقتصادية” حقيقية ضمن نظام ما بعد النزاع.
نقاط الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي: التحديات المتقاطعة في عمليات العودة
تتجاوز الأبعاد الجندرية المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين قضية حقوق الملكية، لتشمل تقاطعات معقدة بين الأمن والضعف الاقتصادي والمكانة الاجتماعية. وتواجه الأسر التي تعيلها نساء – والتي تُشكّل نسبة كبيرة من العائدين نتيجة لوفاة الذكور أو اختفائهم أو استمرار النزوح – تحديات خاصة لا تُعالجها أطر العودة التقليدية بصورة كافية. وتتجلى هذه التحديات في عدة عوامل متداخلة: غياب الحماية الذكورية في بيئات أمنية يسودها الطابع الأبوي، والتهميش الاقتصادي ضمن أسواق عمل تُنظم على أساس الفصل بين الجنسين، والوصمة الاجتماعية المرتبطة بحرية تنقّل المرأة واستقلالية قراراتها.
ولا تقتصر المخاوف الأمنية للنساء العائدات على العنف المنتشر بشكل عام، بل تشمل أيضًا تهديدات محددة على أساس النوع الاجتماعي. فمع انهيار آليات الحماية التقليدية، وعسكرة الذكورة خلال فترة النزاع، نشأت بيئات يستمر فيها العنف الجنسي كامتداد لأنماط الحرب، وأداة للسيطرة الاجتماعية. ويُضاعف من خطورة هذا الواقع غياب أنظمة عدالة فعالة؛ إذ تميل آليات العدالة غير الرسمية التقليدية إلى تفضيل التناغم المجتمعي على حساب حقوق المرأة الفردية، في حين تظل الأنظمة الرسمية إما مغلقة في وجه النساء أو فاقدة للثقة العامة.
ويُطلب من الأرامل العائدات إلى سوريا أن يواجهن ليس فقط التحديات العملية لإعادة الإعمار في غياب الدعم الذكوري، بل أيضًا منظومات اجتماعية تعتبر استقلاليتهن تهديدًا للنظام الأخلاقي القائم. كما أن تدمير القطاعات الاقتصادية التي كانت النساء تهيمن عليها تقليديًا – مثل الإنتاج المنزلي والتجهيز الزراعي – قد قضى على مصادر الرزق المألوفة لهن. وبالتوازي، أدّى اتساع الطابع غير الرسمي للاقتصاد إلى نشوء مواطن هشاشة جديدة، حيث تُحرم النساء العاملات في هذه القطاعات من الحماية القانونية ويواجهن احتمالات الاستغلال. ويُضاف إلى ذلك غياب البنى التحتية لرعاية الأطفال، ما يُقيد مشاركة النساء الاقتصادية، في حين تُفاقم الأعراف الثقافية التي تُقيّد تنقل المرأة من صعوبة وصولها إلى الفرص الاقتصادية الناشئة.
المشهد الأمني المتطور: من العنف المُحتكَر إلى العنف المُشتّت
تشهد البيئة الأمنية في مرحلة ما بعد الأسد تحوّلًا جذريًا في طبيعة التهديد والحماية. ففي حين كان عنف النظام السابق يعتمد على آليات مركزية للمراقبة والاعتقال والقمع المنهجي، يتّسم المشهد الراهن بما وصفته ماري كالدور بسمات “الحروب الجديدة”: عنف لا مركزي، وضبابية في الخط الفاصل بين المدنيين والعسكريين، وتداخل بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
يتجلّى الإرث المادي للصراع بأكثر أشكاله فتكًا في التلوّث بالذخائر غير المنفجرة. وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 220 مدنيًا، بينهم 41 طفلًا، في أوائل عام 2025 وحده، نتيجة لمخلفات الذخائر العنقودية والألغام الأرضية. هذا الواقع يوضّح كيف أن عنف الماضي لا يزال يُنتج انعدامًا للأمن في الحاضر. ويُمثّل هذا التلوث ما يُطلق عليه روب نيكسون “العنف البطيء” – أي شكل من أشكال التدمير المؤجل الذي يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء العمليات القتالية. ويؤدي التوزيع المكاني غير المتكافئ لهذا التلوث، والمتمركز في مناطق القتال الشديد، إلى خلق هرمية جغرافية في مستويات الأمان، تؤثر على أنماط العودة وتُكرّس عدم المساواة بين من يمكنهم العودة إلى مناطق مطهّرة ومن لا يزالون معرضين لمخاطر مستمرة.
الدمار الاقتصادي وأنظمة سبل العيش:
يمثل انهيار الاقتصاد السوري – حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي – تحولًا هيكليًا يتجاوز نطاق الأزمات الاقتصادية الدورية. إن تدمير القدرة الإنتاجية، لا سيما في القطاع الزراعي، كما يتضح من الأضرار الجسيمة التي لحقت ببساتين الزيتون وأنظمة الري، يشير إلى تفكك في أنظمة سبل العيش التي كانت تشكّل الأساس الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع السوري تاريخيًا. ويتجلى هذا الدمار من خلال عدة آليات: التدمير المادي للأصول الإنتاجية، وتفكك شبكات السوق، وتآكل رأس المال البشري بسبب الهجرة القسرية، وانهيار منظومة الوساطة المالية.
تبرز أزمة السيولة الحادة التي تعصف بسوريا أن إعادة بناء الاقتصاد تتطلب ما هو أكثر من مجرد ضخ رأس المال. فقد أدى انهيار النظام المصرفي – نتيجة لهروب رؤوس الأموال النخبوية، وتدمير البنية التحتية، والعزلة الدولية – إلى قطع الصلة الحيوية بين الادخار والاستثمار، ما عطل الآليات التقليدية للتعافي الاقتصادي. ويجبر هذا الاستبعاد المالي العائدين على اللجوء إلى ترتيبات اقتصادية غير رسمية، تُوفر، رغم فاعليتها المؤقتة، استراتيجيات بقاء فورية، لكنها تعيق في الوقت ذاته عمليات التراكم الضرورية لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
البنية التحتية كمساحة سياسية:
لا يُعد تدهور البنية التحتية المادية في سوريا – حيث لا تعمل سوى 57% من المستشفيات و37% من مراكز الرعاية الصحية الأولية – مجرد فشل في تقديم الخدمات، بل يعكس تحوّلاً في شكل ممارسة السلطة. فالبنية التحتية، كما يصفها منظّرو دراسات العلوم والتكنولوجيا، هي “أنظمة اجتماعية تقنية” تنطوي على علاقات سياسية مجسّدة في شكل مادي. وقد مثّل التدمير الانتقائي لشبكات المياه والمدارس والمرافق الصحية خلال النزاع استراتيجية مقصودة لنظام الأسد للسيطرة على السكان؛ ولذلك، فإن عملية إعادة الإعمار تنطوي، بالضرورة، على إعادة تأسيس للسلطة السياسية والعقود الاجتماعية.
ويكشف انهيار البنية التحتية التعليمية بشكل خاص كيف يتداخل الدمار المادي مع تعقيدات الحوكمة. إذ يُشكّل رحيل المعلمين المؤهلين، وتدمير المدارس، وتجزئة المناهج الدراسية، عقبات تتجاوز مجرد تأهيل المباني. ويثير دمج الأطفال الذين تلقوا تعليمهم خلال النزوح وفق مناهج أجنبية في نظام تعليمي سوري يُعاد بناؤه، تساؤلات تتعلق بالهوية الوطنية، والتماسك الاجتماعي، ودور الدولة في عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي. وعلى نحو موازٍ، يكشف انهيار نظام الرعاية الصحية – المتفاقم بفعل هجرة الكوادر الطبية – أن إعادة بناء البنية التحتية تتطلب معالجة متزامنة لعناصر رأس المال البشري، والأطر المؤسسية، والتوافقات السياسية القادرة على جذب الكفاءات المؤهلة والاحتفاظ بها.
الأبعاد النفسية الاجتماعية: الصدمة، والثقة، ورأس المال الاجتماعي
يكشف السياق النفسي المرتبط بالعودة عن تحديات عميقة تتجاوز حدود الاضطرابات الفردية، لتمتد إلى الصدمات الجماعية والتفكك الاجتماعي. وتشير الأبحاث إلى أن معدلات انتشار اضطراب ما بعد الصدمة – البالغة 55.5% – والاكتئاب – البالغة 33.5% – بين اللاجئين السوريين، تعكس أزمة صحة نفسية خطيرة. ومع ذلك، فإن هذه النسب لا تمثل سوى جزء من المشهد النفسي الاجتماعي الأوسع الذي يشكّل واقع العودة، والذي يشمل تآكل الثقة الاجتماعية، وانهيار آليات التضامن المجتمعي، وتبدّل الهويات الاجتماعية بفعل تجربة النزوح.
يوفّر مفهوم “رأس المال الاجتماعي” – المتمثل في شبكات الثقة والتبادل التي تُمكّن من الفعل الجماعي – إطارًا تحليليًا لفهم هذه التحديات. لقد دمّر الصراع السوري بشكل منهجي أنماط التضامن داخل المجموعات، كما قوض العلاقات بين الجماعات المختلفة. وأسهم تسليح الهويات الطائفية والعرقية والسياسية خلال الصراع في تحويل مجتمعات كانت متداخلة ومتكاملة إلى وحدات مفككة يغلب عليها الشك المتبادل. ويحدث هذا التآكل في رأس المال الاجتماعي عبر آليات متعددة: من خيانة الجيران الذين تحولوا إلى مُخبرين، إلى التلاعب بالهويات المجتمعية كوسيلة للبقاء، وصولًا إلى الفصل المادي بين المجتمعات بسبب النزوح.
سياسات مساعدات إعادة الإعمار
يعكس النقص الحاد في تمويل إعادة إعمار سوريا – إذ لم يُتعهد سوى بـ 71 مليون دولار أمريكي من أصل 575 مليون دولار مطلوبة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبرامج العودة – تناقضات أعمق في بنية الاقتصاد السياسي الدولي لما بعد الصراع. ولا يمكن تفسير هذا العجز المالي ببساطة على أنه نتيجة لإرهاق المانحين أو تضارب الأولويات، بل يتقاطع مع حسابات جيوسياسية معقّدة، وأنظمة العقوبات السارية، والتحوّلات في مفاهيم السيادة وشروط تقديم المساعدات الدولية.
العدالة الانتقالية: وعد المساءلة الذي لم يتحقق
يشكّل غياب آليات العدالة الانتقالية الشاملة إحدى أبرز العقبات أمام تحقيق عودة مستدامة وإصلاح اجتماعي حقيقي. فرغم إنشاء لجنة مختصة بالعدالة الانتقالية، فإن الطابع الأولي والهش لهذه الجهود يترك قضايا محورية مثل المساءلة، والحقيقة، والمصالحة من دون معالجة.
خاتمة
يُشير التحليل المطروح في هذه المقالة إلى أن العودة المستدامة تتجاوز ما يُعرف بثالوث العودة “الطوعية، الآمنة، والكريمة”، لتتجسد في “منظومات العودة” – وهي شبكات معقّدة من الظروف المادية، والقدرات المؤسسية، والعلاقات الاجتماعية، والإمكانات النفسية التي تمكّن أو تُقيّد عمليات إعادة الإدماج. وتُظهر الحالة السورية كيف تتداخل هذه العناصر في علاقات تبادلية معقدة: فلا يمكن استعادة حقوق الملكية من دون مؤسسات فعالة، ولا يمكن لتلك المؤسسات أن تعمل من دون توفر حد أدنى من الأمن، ولا يمكن ضمان هذا الأمن من دون وجود ثقة اجتماعية، ولا يمكن ترسيخ الثقة الاجتماعية من دون معالجة الصدمات وضمان العدالة الانتقالية. وهذا التداخل يُشير إلى أن أية تدخلات تقتصر على بُعد واحد – سواءً كان إعادة بناء البنية التحتية، أو الدعم الاقتصادي، أو برامج المصالحة – ستكون غير كافية إذا لم تُدرَك هذه الروابط بوصفها جزءًا من منظومة مترابطة.
في نهاية المطاف، تُظهر تجربة عودة اللاجئين السوريين محدودية التعامل مع العودة كمشكلة إغاثية يمكن حلّها، بدلاً من اعتبارها مسارًا طويل الأمد يتطلب دعمًا دوليا ووطنيا متعدد المستويات. فعمق الدمار – المادي، والمؤسسي، والاجتماعي – يعني أن العودة المستدامة لن تتحقق في غضون سنوات قليلة، بل ستتطلب أجيالًا من العمل المتواصل. ويتطلب هذا الأفق الزمني أطرًا سياسية قادرة على الحفاظ على الزخم والمشاركة، بما يتجاوز الدورات الانتخابية ومصالح المانحين، لتأسيس آليات دعم مستدامة تُقرّ بالعودة بوصفها مشروعًا لإعادة بناء المجتمع، لا مجرد استجابة إنسانية طارئة.
وهكذا، تُجسّد الحالة السورية مأساة فريدة وتحذيرًا عالميًا في آنٍ واحد: ففي عصر النزاعات المطوّلة التي تُنتج تشريدا طويل الأمد، بات من الضروري أن يُطوّر المجتمع الدولي أدوات مفاهيمية وعملية جديدة تتناسب مع تعقيد العودة. أما البديل – وهو استمرار الاستجابات الجزئية التي تكتفي بعلاج الأعراض وتغفل الهياكل – فينذر بإدامة حالة من الضياع، حيث يبقى اللاجئون عالقين بين ماضٍ لا يمكن استعادته، ومستقبلٍ يصعب تحقيقه. وبالنسبة لملايين السوريين الذين يفكّرون في العودة، كما بالنسبة للنظام الدولي المُكلّف بحمايتهم، فإن تحقيق هذا الحقّ يتجاوز مصير الأفراد، ليُعبّر عن إمكانية إعادة بناء المجتمعات المدمرة في عصر الدمار الممنهج.