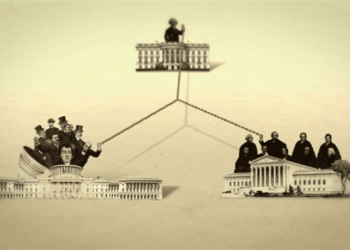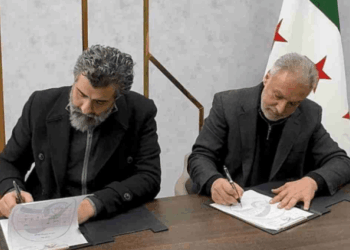فضل عبد الغني
انطلاقاً من تجربتي في توثيق الانتهاكات وعملي في مجال العدالة الانتقالية في سوريا، أؤكد أنَّ غياب مسار جدي للعدالة الانتقالية يمكن أن يخلق نمطاً يومياً قاسياً من التعايش القسري بين الضحايا والجناة في الحي الواحد، وأحياناً في المؤسسة نفسها.
فمع غياب آليات فعالة لكشف الحقيقة والمحاسبة، يواصل بعض الجناة حياتهم في الفضاء العام بلا مساءلة، ما يعمق لدى الضحايا شعور الظلم والعجز ويرسخ ثقافة الإفلات من العقاب بوصفها قاعدة اجتماعية وسياسية. هذا الواقع يضعف الثقة بمنظومة القانون والقضاء، ويدفع بعض الفئات نحو “العدالة الشعبية” أو الانتقام الفردي، بما يحوّل العنف السياسي إلى عنف اجتماعي ممتد ويهدد إمكان بناء هوية وطنية وذاكرة جمعية متماسكة.
ومع الوقت، يصبح حضور المجرمين في المجال العام أمراً “طبيعياً”، أي تطبيعاً للجريمة ذاتها، بما يحمل ذلك من أخطار عميقة على المصالحة واستقرار الدولة الجديدة.
في هذا السياق، تبرز فجوة بنيوية بين أعداد الضحايا الموثقين في قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وأعداد الجناة المعروفين بالاسم، الذين يقاربون 16200 شخص؛ فمعظم الانتهاكات في سوريا كانت جماعية وممنهجة، نفذتها أجهزة أمنية وعسكرية تعمل بتسلسل قيادي صارم وبنية مؤسساتية مغلقة، ما يجعل توثيق الضحايا عبر الشهادات والصور والسجلات الطبية أسهل نسبياً من توثيق المسؤولية الفردية لمن أصدروا الأوامر أو نفذوها.
فهذه المهمة تتطلب تراكباً معقداً من الأدلة والمعايير القانونية الدقيقة. ونتيجة لذلك، تبقى أعداد الجناة الموثقين بالاسم، حتى لو بلغت عشرات الآلاف، أقل بكثير من العدد الفعلي، في ظل انعدام الشفافية، وصعوبة الوصول إلى الأرشيف الرسمي، وقيام الأجهزة السابقة بإخفاء الأدلة وترهيب الشهود والتلاعب بالسجلات.
مسارات المساءلة وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع
ينسحب هذا التعقيد على أوضاع مئات الآلاف من أفراد الجيش والأمن الذين خدموا طوال سنوات النزاع. فمن منظور العدالة الانتقالية كما أفهمه وأعمل عليه، لا يمكن التعامل مع هؤلاء بوصفهم مجموعة مجرمة متجانسة، بل يجب اعتماد فرز دقيق يميز بين فئات متعددة. إذ يجب أن يخضع صناع القرار ومن أصدروا أوامر الانتهاكات أو خططوا لها لمسارات قضائية واضحة ويستبعدوا من مؤسسات الدولة الجديدة.
أما المنفذون الذين عملوا تحت الإكراه أو في ظروف لا تتوافر فيها أدلة كافية على تورط شخصي، فثمة حاجة لمقاربة أكثر تعقيداً تراعي المسؤولية الفردية وضغوط البنية السلطوية وإمكانات إعادة الإدماج المشروط ضمن مؤسسات خاضعة لإصلاح بنيوي ورقابة مجتمعية وقضائية.
وفي جميع الأحوال، تبقى ثقة المجتمع مرهونة بعزل كل من تثبت مشاركته في الانتهاكات الكبرى من دون شيطنة جماعية لكل من ارتدى الزي العسكري أو الأمني.
على مستوى الزمن السياسي، يحمل تأخير إطلاق مسار العدالة الانتقالية أخطاراً كبيرة، فكلما طال التأخير ترسخ الإفلات من العقاب، وتعزز شعور الضحايا بالإقصاء، واتسعت الهوة بينهم وبين مؤسسات الدولة الناشئة، بما يغذي نزعات الانتقام ويعيد إنتاج العنف.
ومع مرور الوقت، يتحول المسار من مشروع تحويلي إلى إجراءات رمزية تستخدم لمنح شرعية شكلية من دون المساس بالبنى التي أنتجت الجرائم. لذلك أرى أنَّ التعجيل المدروس في تفعيل آليات العدالة الانتقالية، في التشريع والمؤسسات، ضرورة وطنية، وأنَّ شرعية المؤسسات الجديدة وثقة المجتمع بها مرهونتان بجدية فتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
مقاربة مركّبة لكشف الجناة غير الموثقين
ومن زاوية منهجية، أقترح مقاربة مركّبة لكشف الجناة غير الموثقين وفق معايير العدالة الانتقالية، تقوم على تلازم ثلاث دوائر: الشهادات المجتمعية، والآليات الوطنية المستقلة، والأدوات الدولية المتخصصة.
في المستوى الأول، تفعيل آليات المساءلة المجتمعية عبر استقبال الشكاوى، وتنظيم جلسات استماع آمنة، وتمكين المجتمع المحلي من تسمية الفاعلين وتوثيق الوقائع ضمن منظومة حماية فعالة للشهود والمبلغين، تشجعهم على تقديم المعلومات من دون خوف من الانتقام أو إعادة الوصم.
في المستوى الثاني، تُنشأ أو تعزز هيئات وطنية مستقلة قادرة على إجراء تحقيقات منهجية وتحليل البيانات الواردة من المنظمات الحقوقية والمصادر المفتوحة وربطها بما يتاح من الأرشيفات الرسمية.
أما المستوى الثالث، فيستفيد من الأدوات الدولية كالآليات الأممية، وصور الأقمار الصناعية، والسجلات الطبية، وأرشيفات الأجهزة الأمنية المتاحة، إلى جانب الدور الحيوي للإعلام الاستقصائي وقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في كشف الحقائق وفتح مسارات جديدة للمساءلة.
بهذه الرؤية، أربط بين العدالة وكشف الحقيقة من جهة، وبين إشراك المجتمع وعدم إقصائه عن عمليات الكشف والمحاسبة من جهة أخرى. فالعدالة الانتقالية، في تصوري، ليست مجرد محاكمات جنائية أو إجراءات إدارية لعزل بعض الأفراد، بل هي عملية مجتمعية عميقة تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الضحية والجاني، وبين الذاكرة الوطنية والمستقبل السياسي.
ومن دون التعامل بجدية مع مأزق التعايش بين الجاني والضحية في ظل الإفلات من العقاب، ومع فجوة التوثيق بين الضحايا والجناة، وتعقيدات المؤسسة العسكرية والأمنية، ومخاطر تأخير العدالة، يظل الانتقال السوري مهدداً بإعادة إنتاج أنماط الاستبداد والعنف التي ثار عليها السوريون في الأصل.