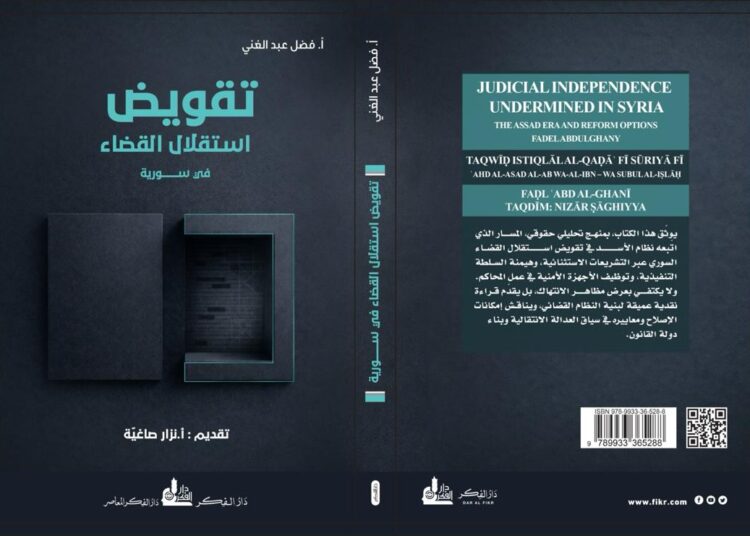على مدى أكثر من خمسة عقود، لم يكن القضاء في سوريا سلطة مستقلة بقدر ما كان جزءًا من منظومة فساد واستبداد، أعادت هندسة القانون ليخدم متطلبات الضبط السياسي والأمني.
فمنذ إعلان حالة الطوارئ عام 1963، مرورًا بالمحاكم الاستثنائية، ووصولًا إلى تشريعات “مكافحة الإرهاب” بعد عام 2011، جرى تفكيك استقلال القضاء بصورة منهجية، وتحويل العدالة من ضمانةٍ للحقوق إلى أداةٍ لإدارة الخوف وإنتاج الطاعة وتدجين المجتمع السوري.
في كتابه الأخير “تقويض استقلال القضاء في سوريا” الصادر عن دار الفكر، يقدّم فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قراءةً تفكيكية لهذا المسار، لا تكتفي بتوثيق الانتهاكات أو توصيف الخلل، بل تحاول الإجابة عن سؤال أكثر تعقيدًا: كيف أُنتجت تبعية القضاء على المستوى الدستوري والمؤسسي والثقافي؟ ولماذا فشلت كل محاولات “الإصلاح الجزئي” في استعادة استقلاله؟
الأهم أن الكتاب لا يقف عند حدود التشخيص التاريخي، بل ينتقل إلى طرح برنامج إصلاحي واقعي لاستعادة استقلال القضاء في سياق المرحلة الانتقالية، واضعاً إصبعَه على مكامن الخلل البنيوي: من رئاسة السلطة التنفيذية لمجلس القضاء الأعلى، إلى منطق الاستثناء الذي أعاد إنتاج نفسه تحت عناوين جديدة، وصولًا إلى غياب الضمانات المؤسسية التي تحمي القاضي من الضغط السياسي والأمني.
في هذا الحوار، يناقش موقع تلفزيون سوريا، مع فضل عبد الغني تفاصيل مضمون كتابه الجديد، كيف أُفرغ استقلال القضاء من مضمونه العملي، وما الذي تغيّر بعد 2011 وما الذي بقي ثابتًا، ولماذا لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية أو دولة قانون دون إصلاح جذري لهندسة السلطة القضائية، وليس الاكتفاء بتعديلات شكلية أو وعود سياسية مؤجلة.
1) ما المشكلة المركزية التي يحاول الكتاب الإجابة عنها: كيف “قُوِّض” استقلال القضاء، أم كيف يمكن استعادته اليوم؟
يرسم الكتاب المشكلة المركزية بوصفها مسارًا مزدوجًا: تفكيكٌ تاريخي–مؤسسي لكيفية تقويض استقلال القضاء بصورة منهجية عبر عقود، وفي الوقت ذاته تقديم مدخل إصلاحي لاستعادته ضمن شروط واقعية. فالكتاب يسأل عن الكيفية التي “حوّلت” القضاء من وظيفةٍ معيارية هدفها تحقيق العدالة وحماية الحقوق، إلى أداةٍ في يد السلطة التنفيذية عبر آليات سياسية وقانونية وإدارية متشابكة.
ومن ثمّ، فاستعادة الاستقلال –بحسب منطق الكتاب– ليست “عودةً تلقائية” بمجرد تغيير النصوص أو إلغاء مؤسسة استثنائية هنا أو هناك؛ بل هي إصلاح بنيوي يطال هندسة السلطة القضائية، واستقلالها المالي والإداري، وضمانات المحاكمة العادلة، وإعادة ضبط علاقة القضاء بالأمن ضمن دولة القانون.
2) ما أبرز الآليات الدستورية التي جعلت استقلال القضاء إعلانًا شكليًا أكثر منه واقعًا عمليًا؟
يحدد الكتاب آليةً دستورية محورية تجعل استقلال القضاء في عهد الأسدين أقرب إلى صيغةٍ إعلانية: منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تشمل تعيين القضاة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يؤدي عمليًا إلى “مركزة” القرار القضائي ضمن نطاق السلطة التنفيذية، وتقليص قدرة القضاة على إدارة شؤونهم أو بناء رقابة داخلية مستقلة على التعيين والترقية والتأديب.
ويضيف الكتاب أن النصوص التي تتضمن إشارات إلى استقلال القضاء غالبًا ما تُقرن بصياغات تسمح بتجاوز هذا الاستقلال بذريعة “ضرورات الأمن” أو “المصلحة العامة”، بما يحول مبدأ الاستقلال إلى مبدأ قابل للتعطيل السياسي في القضايا ذات الطابع الأمني أو السياسي.
3) كيف أثّرت حالة الطوارئ الممتدة منذ 1963 على الثقافة القضائية وعلى علاقة القاضي بالأجهزة الأمنية؟
يربط الكتاب بين إعلان الطوارئ منذ 8 آذار/مارس 1963 وبين إعادة تشكيل البيئة القانونية بحيث تُمنح السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية غطاءً قانونيًا للالتفاف على الضمانات الدستورية، خصوصًا في الحريات العامة. وعلى المستوى القضائي، يبرز الأثر الأوضح في تحجيم دور القضاء في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومنح الأجهزة الأمنية سلطات شبه مطلقة في التوقيف والتحقيق دون قيود تُذكر.
الأهم –وهو بعدٌ “ثقافي” طويل الأمد– أن هذا الوضع الاستثنائي رسّخ داخل الجسم القضائي منطق الخطوط الحمراء: شعورٌ ضمني لدى قضاةٍ كثيرين بأن ثمة قضايا لا ينبغي الاقتراب منها، وأن المسار الأمني يسبق المسار القضائي ويعلوه. ومع مرور الزمن، تصبح هذه القيود غير المعلنة “تقاليد” تؤثر في السلوك المهني للقاضي وفي توقعاته عن حدود وظيفته داخل نظامٍ تُغلّب فيه الاعتبارات الأمنية على استقلال القضاء وسيادة القانون.
4) ما الدور الذي لعبته المحاكم الاستثنائية في إعادة تشكيل العدالة من ضمانةٍ للحقوق إلى أداةٍ للضبط السياسي؟
يرى الكتاب أن المحاكم الاستثنائية كانت قلب البنية الضابطة التي أعادت تعريف العدالة باعتبارها وظيفة “أمنية”. فمنذ لحظة الطوارئ، بدأت تتبلور محاكم موازية –وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة العليا– سُحبت إليها القضايا السياسية أو “الحساسة”، مع تجاوز الأصول الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب واعتماد إجراءات سرية في التحقيق والمحاكمة.
وتفصيلاً، يوضح الكتاب أن محكمة أمن الدولة العليا نشأت ضمن سياق قانوني استثنائي، وأُعطي وزير الداخلية (بوصفه نائب الحاكم العرفي) سلطة إحالة القضايا التي يرى أنها “تمس أمن الدولة”، بما يجعل اختصاص المحكمة مرتبطًا مباشرة بالتصنيف الأمني لا بالمعيار القضائي الطبيعي.
5) بعد 2011: كيف غيّر الانتقال إلى “مكافحة الإرهاب” طبيعة المحاكمة، وما الذي بقي ثابتًا من منطق الاستثناء؟
يقرر الكتاب أن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا عام 2011 لم يؤدِّ إلى تفكيك منطق الاستثناء، بل جرى إعادة إنتاجه في إطار جديد عبر إنشاء محكمة مكافحة الإرهاب عام 2012، اعتمادًا على تشريعات “مطاطة” سمحت باستمرار الممارسات القمعية بغطاء قانوني جديد.
ويشرح أن قوانين “مكافحة الإرهاب” صيغت بصورة غامضة، دون تعريف دقيق للفعل الإرهابي، بما مكّن من إدراج أنشطة سلمية كالتظاهر أو التغطية الإعلامية الناقدة ضمن الجرائم الإرهابية، مع توسيع صلاحيات الاعتقال والاستجواب والحبس الاحتياطي المطول، الأمر الذي يزيد قابلية المحتجزين للتعذيب والإكراه، ثم إحالتهم إلى محاكم خاصة ذات صبغة أمنية تفتقر لمقومات العدالة.
كما يورد الكتاب، في سياق تعزيز النفوذ الأمني بعد 2011، حزمة تشريعات محددة (قانون 19 لعام 2012، والمرسوم 63 لعام 2012، والقانون 22 لعام 2012) أسست لتوسيع الاعتقال ومصادرة الأموال وإنشاء محكمة استثنائية تُبنى أحكامها بصورة كبيرة على تقارير الأجهزة الأمنية مع ضمانات دفاع محدودة.
6) كيف تعاملت المنظومة القضائية مع ادعاءات التعذيب والاعترافات المنتزعة بالقوة؟ وكيف ينعكس ذلك على معيار المحاكمة العادلة؟
يعرض الكتاب نمطًا بالغ الدلالة في عهد الأسدين: تحول الاعتراف القسري إلى ركيزة إثبات في القضايا السياسية والأمنية، دون فتح تحقيق قضائي مستقل وفعّال في مزاعم التعذيب. ففي تحليل محكمة أمن الدولة العليا، يذكر الكتاب أن تقارير حقوقية وثّقت أن معظم من مثلوا أمامها تعرضوا لانتهاكات جسدية ونفسية في الفروع الأمنية، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية استُخدمت أساسًا للإدانة.
وينعكس هذا مباشرة على معيار المحاكمة العادلة كما يورده الكتاب بالمقارنة مع المعايير الدولية، إذ يضع اعتماد الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه في تعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب، ويقرنه كذلك بخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، التي تؤكد ضرورة إبعاد التنفيذية عن تعيين القضاة والتأثير عليهم.
7) كيف أثرت رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ودور وزير العدل في ترسيخ تبعية القضاء؟
يقدم الكتاب تفسيرًا مؤسسيًا مباشرًا: مجلس القضاء الأعلى، وفق الدستور وقانون السلطة القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية ويكون وزير العدل نائبًا للرئيس عند غيابه، مع عضوية لكبار القضاة والمدعين العامين ومناصب مرتبطة إداريًا بالدولة. ويؤكد أن تعيين أعضاء المجلس يجري بحكم مناصبهم دون آلية انتخابية أو ضمانات استقلال، بما يجعل تشكيل المجلس مرتبطًا بالسلطة التنفيذية ارتباطًا وثيقًا.
ثم يخلص الكتاب إلى أن هذه الهندسة تُفرغ النصوص الدستورية عن الاستقلال من أثرها العملي؛ لأن رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، يتمتع بصلاحيات واسعة في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وحتى عزلهم، ويعزز وجود وزير العدل –كممثل للسلطة التنفيذية– هذا الواقع، فتتكرس تبعية الإدارة القضائية للإرادة التنفيذية بدل أن تكون ضمانة مهنية لاستقلال القضاة.
8- ما برنامج الإصلاح الذي يقترحه الكتاب لاستعادة استقلال القضاء في سوريا، وما أولوياته العملية في المرحلة الانتقالية؟
يقترح الكتاب إصلاحًا بنيويًا يستهدف “مراكز إنتاج التبعية” داخل المنظومة القضائية، لأن الاستقلال –بحسب منطق الكتاب– تعطل عبر هندسة دستورية وإدارية وتشريعية جعلت القرار القضائي قابلًا للاحتواء التنفيذي والأمني.
وعلى المستوى العملي، يضع الكتاب أولويات متدرجة يمكن تلخيصها في ثلاث حزم مترابطة:
- إعادة بناء الحوكمة القضائية وفك الارتباط التنفيذي: أي إصلاح مجلس القضاء الأعلى وآلية تشكيله وصلاحياته بما يضمن استقلاله الفعلي، لأن المجلس يمسك بمفاتيح التعيين والترقية والنقل والتأديب، وأي بقاء للهيمنة التنفيذية عليه يعيد إنتاج التبعية مهما تبدلت القوانين.
- إغلاق مسارات الاستثناء وإعادة الاعتبار للمحاكمة العادلة: يركز الكتاب على ضرورة تفكيك الإرث الاستثنائي الذي حوّل العدالة إلى أداة ضبط سياسي، وذلك عبر منع إعادة إنتاج محاكم موازية أو قوانين فضفاضة، ومعالجة التشريعات التي وسّعت سلطة الاعتقال والمصادرة والمحاكمة الخاصة تحت عناوين مثل مكافحة الإرهاب.
- تعزيز الضمانات المؤسسية والموارد والرقابة: يوضح الكتاب أن استقلال القضاء لا يتحقق دون استقلال مالي وإداري وحماية مهنية للقضاة، إلى جانب تفعيل رقابة دستورية أكثر استقلالًا عبر إصلاح آلية تشكيل المحكمة الدستورية وتوسيع إمكانات الطعن والرقابة على التشريعات المقيدة للحقوق.
وخلاصة هذا البرنامج أن الإصلاح الناجح يبدأ بإعادة ضبط “الهيكل” الذي ينتج التبعية، ويُغلق منافذ الاستثناء، ويُعيد بناء الضمانات التي تجعل القضاء قادرًا على أداء وظيفته كسلطةٍ ضامنة للحقوق وركيزةٍ للعدالة الانتقالية وسيادة القانون.